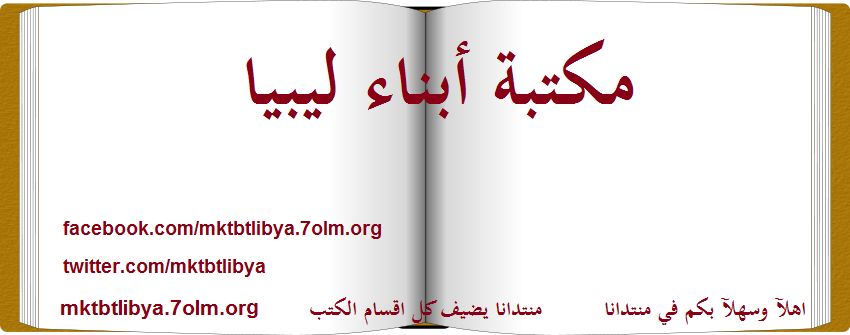وجدته يضرب كفا بكف وهو في حيرة من أمره عاجزا عن اتخاذ القرار المناسب بشأن استخدام أبنائه مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يسمى الإعلام الجديد، متسائلاً: هل المنع هو الحل أم السماح والتوجيه أفضل؟
وقبل أن أجيب عن سؤاله قلت له ماذا تخشى من هذه المواقع؟
فقال إن أبنائي يتعرضون من خلال هذه المواقع لرسائل كثيرة ومتنوعة في جميع المجالات بما في ذلك المجالات السياسية والأمنية والدينية والجنسية ويتفاعلون معها دون وعي يمكنهم من التعاطي الإيجابي مع هذه الرسائل ولا يمكن لي أن أكون رقيباً على ما يشاهدون وكيف يتفاعلون مهما بذلت من جهود.
قلت له لا أخفيك أن الكثير مثلك وأنا أحدهم، فنحن جميعاً في حيرة من أمرنا ولا نعرف حتى الآن القرار السليم وإن أصبح الأمر واقعاً حيث بات الأطفال، فضلاً عن الشباب، يحملون أجهزة الهاتف الذكية ولديهم حسابات في المواقع الاجتماعية بأسماء وأعمار مزورة ويتعرضون من خلالها لرسائل متنوعة لا تتناسب وأعمارهم ومستوى وعيهم.
نعم فنحن نواجه ما لم يواجهه أحد من قبلنا من آباء حيث مكّن التزاوج بين التقنية والاتصالات من تطوير مواقع تواصل مكنت الجميع من التواصل مع من يشاء ومكنتهم من الرد والتفاعل في العالم الافتراضي ومن ثم التواصل والتفاعل في العالم المادي من وراء ظهورنا إن شاءوا ولا يمكن لنا أن نراقبهم ونشكك في سلوكياتهم، فالأصل في العلاقة معهم يجب أن تقوم على الثقة وإلا أصبحت الحياة معقدة وصعبة جداً.
أذكر أنني قرأت كتاب "الطرف الطويل" منذ أكثر من ثلاث سنوات وفيه قال الكاتب إن العالم نتيجة للتطورات في عالمي الاتصال والتقنية وتزاوجهما سيتعرض "لوابل" من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وها نحن اليوم نرى هذا "الوابل" ونقف في دهشة من أمرنا أمامه، فلا تجارب سابقة تبين لنا النموذج الأمثل وليس أمامنا سوى الاجتهادات في التعاطي مع هذا الواقع الجديد.
ومن خلال الحوار مع صديقي هذا توصلنا إلى قرار أن نعمل على رفع مستوى وعي أبنائنا وأن نبادر بإيضاح الأمور لهم مهما كانت محرجة قبل أن يقوم بهذا الدور من يوقع بهم في حبائله الفكرية أو الجنسية أو غير ذلك، إذ إننا لا يمكن أن نعزل أبناءنا عن واقعهم، كما لا يمكن لنا أن نتركهم دون توعية ومتابعة ونصح وتوجيه مستمرين مع الدعاء لهم بالتوفيق والسداد.
أجزم أن واقع الآباء المؤلم الذي يعيشونه اليوم مع قضية تربية أبنائهم وتوعيتهم وتوجيههم لحمايتهم من مساوئ التواصل الاجتماعي أو الإعلام الجديد وما قد يترتب عليه من مخاطر ومسؤوليات جسام أمام الآخرين وأمام الدولة. أجزم أن هذا الواقع تعيشه حكومات المنطقة العربية التي وجدت نفسها أمام منتجات غربية تتناسب وواقع هذه الدول السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومستوى وعي أفراد تلك الدول في كل هذه المجالات والمجال القانوني والأمني أيضاً.
وجدت حكوماتنا نفسها أمام منتجات يستخدمها مواطنوها لتشكيل كتل اتصالية تتواصل بوعي سطحي في كثير من القضايا وكأنها عميقة الوعي والفهم والإحاطة بكل التفاصيل وتتفاعل وتتخذ مواقف وقرارات وأفعالا حيال هذه القضايا التي عادة ما تسميها مشاكل، الأمر الذي يزعزع كيانات هذه المجتمعات ويجعلها في مهب الريح وفي موقف ضعيف أمام مواجهة خطط الآخرين الذين يستهدفون تحقيق مصالحهم على حساب مصالح دولنا التي تتمتع بخيرات كبيرة وكثيرة مقرونة بوعي متواضع.
ولا يخفى على أحد ما هو حاصل في معظم الدول العربية غير الخليجية من مشاكل ومآس وزعزعة حتى بات الكثير منها في حكم الدول الفاشلة التي لا تسيطر حكوماتها على بعض تكتلاتها البشرية أو بعض مواقعها الجغرافية.
ما حدث في دول الجوار المحيطة بالدول الخليجية التي تفاعلت بشكل متفاوت مع كل ما حصل ويحصل في بقية الدول العربية جعلنا نخلص إلى كثير من الحقائق والعظات، ومن يتعظ بغيره فقد أفلح.
نعم رأينا هذه الدول وقد تحول بعضها إلى ركام، والبعض الآخر فقدت حكوماتها المركزية السيطرة على البلاد، والآخر في أسوأ أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية حيث القتل والاعتقالات ومنع التجول وغير ذلك.
بل إن الأمر وصل إلى مستوى لم يكن ليصدقه أحد بعد أن استخدم النظام السوري الأسلحة الكيماوية في ضرب الأحياء بعد أن دكها بكل أنواع الأسلحة من الأرض والجو.
ودون أدنى شك فإن هذه الأحداث تجعلنا في قلق وخوف من المستقبل، خصوصاً أن شباب المنطقة الذي ارتفع سقف بعضه الفكري دون قاعدة فكرية سليمة وقوية أصبح في حالة تفاعل كبيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع القضايا الدائمة (التعليم، الإسكان، البطالة، العلاج، والبنى التحتية) ويسميها أسماء لا تمت للواقع بصلة كالأزمات أو الكوارث رغم أننا وفق المعايير الدولية القائمة على المقارنة في حال متقدم في كثير من هذه القضايا التي تبذل الحكومة جهوداً كبيرة للتعاطي معها ووضعها في نطاق النسب المعيارية العالمية.
لذلك نرى الدولة توسعت في الجامعات والابتعاث الخارجي وإنشاء وتشغيل المستشفيات وتطوير البنى التحتية بشكل لافت للنظر وتوفير فرص عمل للشباب حتى بات الشباب السعوديون المؤهلون ندرة يتنافس عليها عارضو الفرص الوظيفية.
ختاماً أتطلع إلى أن تقوم الحكومة بعرض ذكي ومقنع لفكرها وتطبيقاته وإنجازاتها في مجال خدمة المجتمع والتعاطي مع قضاياه الدائمة كالصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والبنى التحتية وتنمية الأسواق من خلال حملة اتصالية إقناعية ترفع مستوى وعي الشباب بما تحققه الدولة من نجاحات في إطار التفاعل مع المشهدين الداخلي والخارجي اللذين يتفاعلان في ظروف أكثر من حساسة ليلعب شبابنا دورهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية مكتسبات الوطن وتنميته.